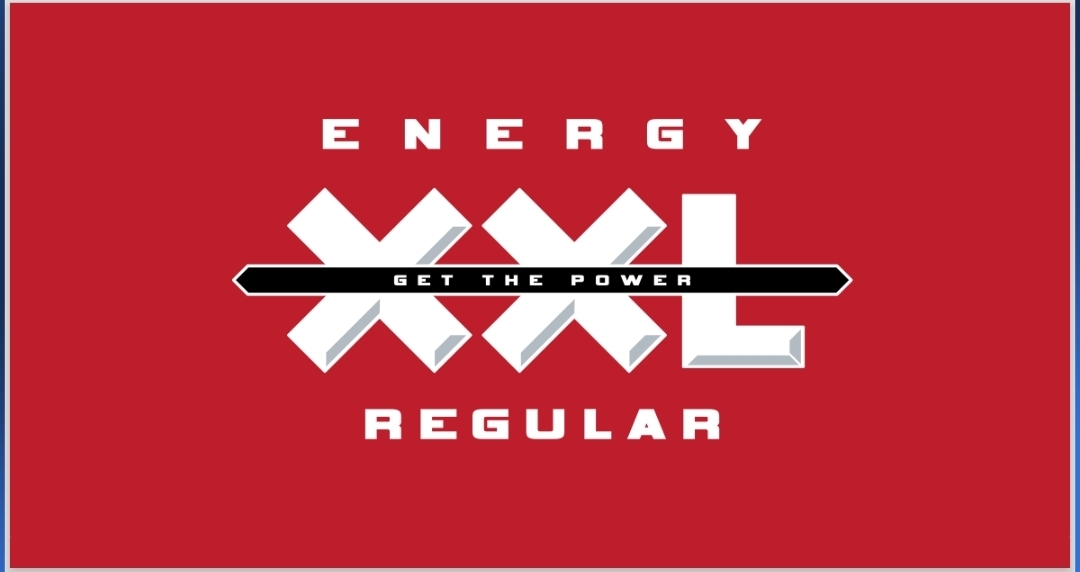كتبت راغدة درغام في “النهار العربي”:
الفارق بين الأزمة التايوانية والحرب الأوكرانية هو أن انزلاق تايوان الى مواجهة صينية – أميركية ستكون تداعياته عالمية، اقتصادية وتكنولوجية ومالية تمتحن النظام العالمي برمّته. أما الحرب الأوكرانية، فبالرغم من خطورة تطوّرها الى حرب عالمية وما شهدناه من انعكاسات لها خارج القارة الأوروبية، من الحبوب الى النفط، فإنها بالمقارنة تبقى أزمة محليّة وليست كونيّة، أقلّه حتى الآن، ما لم تتطوّر الى حرب نووية بين الغرب وروسيا.
الفارق الآخر هو أن الصين لا تستجدي التعاطف مع جانبها في النزاع وتفضّل أن تتبنى الدول الحياد، فيما روسيا تبحث عن حلفاء بجانبها كما دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، فهي أيضاً تستثمر لتوسيع رقعة التحالف معها ضد روسيا في الحرب الأوكرانية. أوكرانيا تختبر الولايات المتحدة لجهة قيادتها الأوروبية وقدرتها على تحقيق “تقزيم” روسيا في ساحة صنع القرار العالمي. تايوان تدفع بكل من الصين والولايات المتحدة الى الاختبار، في حين أن كلاً منهما يسعى الى إلغاء الآخر في موازين الاستفراد بالعظمة والقيادة العالمية على المدى البعيد. العالم يراقب عن كثب متمنياً ألا يتصادم هذان العملاقان بسبب تايوان، وكثير من الدول يتخذ احتياطاته.
المنطقة العربية، خصوصاً الخليجية، لا تجد نفسها مضطرة لاتخاذ موقف ضد أو مع الصين أو الولايات المتحدة، فتايوان ليست معركتها وهي ستلتزم الحياد الى أقصى الدرجات ما لم تفرض عليها التطورات التصويت في الأمم المتحدة. الا أن العلاقات الخليجية التي تتطوّر مع الصين على مختلف الأصعدة تستدعي التوقف عند أسباب تراجع دفء العلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة، لعل ذلك يساعد في فهم وتفهّم الآخر أكثر.
ليس من قبيل المصادفة اختيار الرئيس الصيني شي جينبينغ تعبير “الثقة الاستراتيجية” كأساس للعلاقات الصينية – العربية والصينية – الخليجية أثناء قمم الصين في الرياض، الثنائية والخليجية والعربية. أزمة الثقة بالولايات المتحدة يعترف بها القادة الأميركيون أنفسهم انطلاقاً من عدم ثبات السياسات الأميركية وعدم تماسكها مع مفاجآت انعطافاتها المدهشة.
الجديد في الأمر أن الصين قررت أن افتقاد الثقة العربية بثبات السياسات الأميركية يشكل فسحة استثمار لها تماماً في ذلك النقص defficiency. قررت استدعاء الثقة العربية، ليس فقط في ثبات المواقف الصينية الاقتصادية والسياسية والتجارية، وإنما أيضاً في ثبات مبادئ العلاقات بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية أو في نوعية الحكم في هذه الدول.
سيقال إن الصين هي أبعد ما يكون عن الديموقراطية وأقرب ما يمكن من الأوتوقراطية، وبالتالي لا تهمّها “القيم” التي تلوّح بها الإدارة الأميركية في وجه دول العالم باعتبارها تمثل عنجهية “الاستثنائية الأميركية” American exceptionalism. هذا صحيح. فالصين تعارض إصرار الولايات المتحدة على فرض أجندة حقوق الإنسان والحريات والمحاكم العادلة، وهي تصرّ على نموذج حكمها القائم على الشيوعية ومبادئ انحسار حقوق الفرد والفردية.
ما تتقنه الصين هو لغة المصالح بكل ما تقتضيه من تأقلم أو مقايضات، وهي قد جعلت ذلك أساساً في مسيرة “الحزام والطريق” التي تشكل استراتيجيتها الأساسية للعلاقات مع الدول. ولكي لا ترتطم بما تعتبره الصين ليس من شأنها، تبنّت سياسات احترام الحساسيات، وتقبّل اختلاف الأيديولوجيات، والإصرار على مبدأ عدم التدخل في الدول العربية، لا سيما الدول الخليجية التي تربطها بها علاقات تجارية هائلة يصل مجموعها الى أكثر من 300 مليار دولار.
في المقابل، تتبنى الولايات المتحدة سياسات تتجاهل “استثنائية” الطرف الآخر وتتوجّه الى الدول الخليجية العربية بدفتر شروط لغته أميركية لا تأخذ في الحساب اختلاف الثقافات والعادات. على سبيل المثال، قلّ ما فهم المسؤولون الأميركيون محوريّة “الديوانية” في العلاقات بين المواطن والمسؤول الخليجي. الحزب الديموقراطي بالذات يتباهى بتأبطه نص “حقوق الإنسان” علماً أنه سبق واستُخدِم مراراً لغايات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان على الإطلاق. إنما هذا لا ينفي أبداً أن إدارة جو بايدن محقّة في كثير من مواقفها المنبثقة من مبادئ الحرية وضرورة المحاسبة على الانتهاكات.
أما تبعثرها، فإنه يتخذ مختلف المسالك المنبثقة أحياناً من الفوقية الأميركية في وجه الفوقية الخليجية، وأحياناً من سوء تقدير وسوء قراءة السياسات وسوء التعبير. ما قاله الرئيس جو بايدن تعليقاً على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد توقيع اتفاق بينهما بوساطة صينية، مثال.
فالرئيس الأميركي لم يكن موفّقاً عندما علّق بقوله: “كلما كانت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع”. فبدا بذلك مستهزئاً بالوساطة الصينية ومستخفّاً بقرار السعودية تحسين العلاقات مع إيران بدلاً من الانضمام الى “اتفاقيات ابراهام” مع إسرائيل، لا سيما وأن إسرائيل لم تحسِّن أداءها نحو الفلسطينيين ولم “تبيّض” وجه الدول العربية التي طبّعت معها. فالتقارب السعودي مع إسرائيل ليس مكسباً أكبر للسعودية من التقارب مع إيران ومع الصين، وكان أفضل للرئيس الأميركي ألاّ يدخل مثل هذه المتاهات ويضاعف الانطباع بأن أميركا لا تفهم أبداً، لا السعودية ولا بقية الدول الخليجية.
ثم أن النتيجة للتفاهمات السعودية – الإيرانية برعاية وضمانة صينيتين دخلت فوراً حيز التنفيذ – أقله حيز الاختبار – في ملف اليمن الذي أخفقت الدبلوماسية الأميركية في معالجته، جزئياً بسبب المواقف الأميركية العدائية تلقائياً نحو السعودية. بل أن الضمانات في المساعي الصينية هي التي أقنعت السعودية بالتفاوض مع إيران. وهكذا تصرّفت الصين بأفعال نحو بناء الثقة الاستراتيجية بها كشريك جدّي وثابت ومتماسك وقادر على تحقيق الإنجازات.
كل هذا لا يلغي العلاقات الأمنية الأساسية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية العربية. فأمن الخليج ضرورة للأمن العالمي ولاستقرار أسعار النفط. صحيح أنه ليس هناك قواعد أميركية في السعودية اليوم، لكن القواعد موجودة في قطر والكويت وفي البحرين. ثم أن التكنولوجيا الرادعة استبدلت القواعد التقليدية، وما حاملات الطائرات بما فيها النووية لأول مرة في الخليج سوى مثال. وبالتالي أن الصين لم تصبح فجأة الشريك الأمني البديل لأميركا مع الدول الخليجية العربية، وإنما العلاقة الأمنية لا تزال حكراً على الولايات المتحدة في علاقة استراتيجية ستبقى مستمرة.
الاستياء أو الاستقلال الذي تعبّر عنه الدول الخليجية لأول مرة بصراحة وعزم لن يدمّر علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، إنما ستكون له انعكاسات في ملفات الخلاف والاختلاف الأميركي – الصيني، سواء الاستراتيجي منه، أو في شأن تايوان.
فكما البراغماتية الأوروبية اقتضت أن تتحدث الدول الأوروبية الشريكة للولايات المتحدة في حلف “ناتو” وفي الحرب الأوكرانية بلغة حيادية في ملف تايوان، كذلك اقتضت البراغماتية الخليجية. فهذا ملف بين الولايات المتحدة والصين، وليس بين الغرب والصين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بعد عودته من زيارة الصين، إن أوروبا ليس لديها مصلحة في زيادة حدّة الأزمة بشأن تايوان وأنها يجب أن تنتهج استراتيجية مستقلة عن كل من واشنطن وبكين. اللافت هو ما قاله إن “على أوروبا ألاّ تسرّع وتيرة هذا الصراع بل أن تأخذ الوقت الكافي لبناء موقعها كقطب ثالث بين الصين والولايات المتحدة”. بل أنه أضاف، بحسب صحيفة “بوليتيكو”، أن “أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا، نحن الأوروبيين، يجب أن نصبح أتباعاً في هذه المسألة وأن نتكيف مع الإيقاع الأميركي أو رد الفعل الصيني المبالغ فيه”.