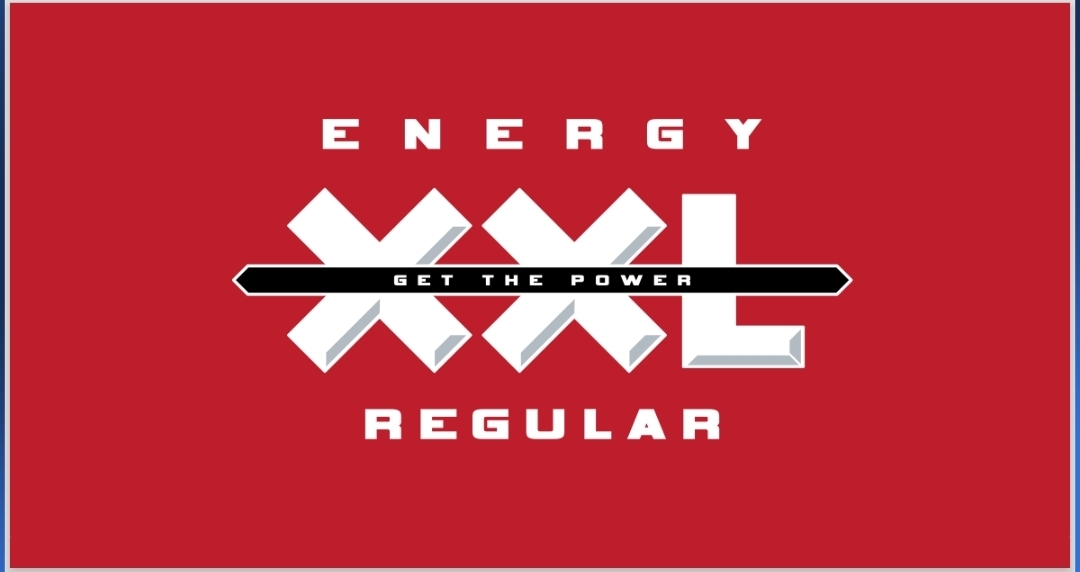د. بيار الخوري – مركز السياسات والاستشراف المعرفي ( مسام)
اندلعت مواجهة عسكرية مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يومًا (13–25 يونيو 2025)، وانتهت بوقف إطلاق نار دون منتصر حاسم. تكبّدت إيران خسائر فادحة في البنية التحتية والأرواح، حيث قُتل ما لا يقل عن 610 إيرانيًا جراء الضربات الإسرائيلية شملت قادة عسكريين وعلماء نوويين. في المقابل، أدّت الصواريخ الإيرانية إلى مقتل 28 شخصًا في إسرائيل، والدمار الكبير بعد انكشاف الاجواء امام الصواريخ الايرانية رغم المساعدة الأمريكية في اعتراض غالبية المقذوفات.
عسكريًا، أعلنت إسرائيل أنها حققت أهدافها من عملية “أسد صاعد” عبر تدمير عشرات المواقع النووية والصاروخية الإيرانية واغتيال قيادات بارزة، مع تأكيدها السيطرة الجوية الكاملة خلال النزاع. وأظهرت الحرب عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل إيران، إذ استطاع الموساد “خلق فيلق من المنشقين” ألحقوا أضرارًا جسيمة من الداخل. بالمقابل، ورغم الضربات الموجعة، حافظت القيادة الإيرانية على تماسكها وساهمت في فرض وقف إطلاق النار على عدوها.
مع ذلك، فإن غياب النصر الحاسم يعود لجملة أسباب.
فعلى الصعيد العسكري، ورغم الدمار الكبير الذي لحق بقدرات إيران النووية والصاروخية، لم تنجح الحملة الإسرائيلية-الأمريكية القصيرة في القضاء الكامل على برنامج إيران النووي أو ترسانتها الباليستية. جزء من البنية التحتية النووية الإيرانية نجا من القصف، بما في ذلك مخزون يزيد عن 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ تم نقله لموقع سري قبل الضربات. هذا يعني بقاء قدرة كامنة لدى طهران لإعادة بناء برنامجها النووي سرًا، مما أبقى هاجس الخطر النووي قائمًا. في الوقت نفسه، أظهرت إيران قدرة على الصمود والردع عبر إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن إسرائيلية، تمكن بعضها من اختراق الدفاعات والتسبب بخسائر مادية وإصابات بالعشرات. هذا الرد الصاروخي المكثف – وإن لم يُحدث أضرارًا استراتيجية جسيمة – بعث رسالة بأن لدى طهران قدرة إيذاء لا يستهان بها، مما قيّض سردية الانتصار الإسرائيلي ومنع إخضاع إيران.. يضاف إلى ذلك عامل الضغط الدولي والتدخل الدبلوماسي؛ فعندما بدا أن الصراع قد يتوسع إقليميًا بعد استهداف إيران لقاعدة أمريكية في قطر، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان التوصل لوقف شامل لإطلاق النار يوم 24 يونيو قبل خروج الأمور عن السيطرة. هذا التحرك الأمريكي جاء استجابة لمخاوف عالمية من انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب أوسع، وضغوط من دول كبرى وإقليمية لاحتواء الموقف. بهذه العوامل مجتمعة – التوازنات العسكرية المتبادلة والضغوط الخارجية – توقف القتال عند حدود “نصف انتصار” لكل طرف: إسرائيل أضعفت خصمها دون أن تقضي عليه، وإيران نجت بنظامها وهددت نظام الامن الداخلي الاسرائيلي.
سياسيًا، خرج الطرفان يعلنان النصر ويعزفان على وتر الدعاية الداخلية. الحكومة الإسرائيلية تباهت بإنجازاتها العسكرية غير المسبوقة ضد طهران وادّعت أنها أزالت الخطر الوجودي النووي الإيراني .بالمقابل، ايران سوّقت داخليًا صمودها واعتبرت نجاحها في إجبار إسرائيل على وقف الحرب إنجازًا، بل واحتفل بما أسماه انتصارًا للمنطق الإيراني في عدم الرضوخ للإملاءات. لكن خلف هذه الادعاءات، يُجمع المراقبون على أن كلا الجانبين خرج مثخنًا والجراح الإستراتيجية عميقة. إيران دفعت ثمنًا عسكريًا واقتصاديًا هائلًا؛ فترسانتها الصاروخية والمسيّرة “تضررت بشدة” والعديد من قادتها العسكريين لقوا حتفهم، ما ترك مكانتها الإقليمية وهيبتها الوطنية نوضع مسائل. باحث في معهد جنيف، وصف ما جرى بأنه “كارثة لإيران”، بينما اعتبر خبير منع الانتشار روبرت أينهورن أن إيران أصبحت أضعف وأكثر عزلة دوليًا مما كانت عليه قبل أسبوعين. وعلى الرغم من الضربات الهائلة، فإن أخطر ما خلفته الحرب هو تعزيز دافع الصقور في طهران للسعي إلى امتلاك السلاح النووي كضمانة ردع أخيرة. فقد أثبتت الأيام الـ12 أن اعتماد إيران على الصواريخ والحلفاء الإقليميين لم يكن كافيًا لردع عدوها، ما قد يغذي تيارًا داخل النظام يرى القنبلة النووية سبيل البقاء الوحيد أمام أي تهديد وجودي. هذا الإرث الخطير للصراع ينذر بسباق تسلح نووي إقليمي إذا لم يتم تداركه بالجهود الدبلوماسية.
على الجانب الآخر، إسرائيل وإن حققت إنجازات تكتيكية معتبرة، إلا أنها وجدت نفسها بعد وقف النار أمام معضلة استراتيجية: ماذا بعد تدمير المواقع النووية؟ فالبرنامج الإيراني لم يُجتث تمامًا، وإمكانية إعادة بنائه واردة، ما يعني أن التهديد قد يعود بشكل أكثر خطورة وفي غياب إطار اتفاق نووي يكبحه. كما أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية وإقليمية لسلوكها “العدواني” أحادي الجانب، حيث لم يحظ قصفها للأراضي الإيرانية بإجماع من حلفائها التقليديين. وقد عارضت دول عربية رئيسية الهجوم الإسرائيلي منذ البداية واعتبرته تهديدًا لأمن المنطقة، مما ترك إسرائيل سياسيًا في شبه عزلة إقليمية خلال الحرب. أما داخليًا في إسرائيل، ورغم الدعم الشعبي الواسع للعملية العسكرية في البداية، فإن التكلفة البشرية (28 قتيلًا مدنيًا وإصابة المئات والدمار المادي الواسع) والتأهب لمدة 12 يومًا في الملاجئ أحدثت حالة استنزاف نفسي واقتصادي. استمر إغلاق المدارس والأعمال في مناطق واسعة وجرى تعطيل الحياة الطبيعية تحت تهديد الصواريخ. كذلك، أيقن الإسرائيليون أن منظومتهم الدفاعية – رغم نجاحها الكبير – ليست منيعة بالكامل، ما يعني أن شبح التهديد الصاروخي سيبقى حاضرًا بقوة. في المحصلة، انتهى النزاع إلى تهدئة بلا سلام مستدام: توقف القتال العلني لكن جذور الصراع النووي والجيوسياسي ظلت دون حل، وبقي ميزان القوى الإقليمي غير مستقر وقابل للاشتعال من جديد ما لم يُعالج بتسوية أشمل.
اقتصاديًا، تسببت الحرب بارتدادات اقتصادية فورية على إيران وإسرائيل والمنطقة ككل. إيران التي ترزح أصلًا تحت عقوبات أمريكية مشددة واجهت أزمة أعمق مع تدمير منشآت حيوية (كمجمعات نووية ومنشآت نفطية) واضطراب حركة التجارة والنقل خلال القصف. تشير التقديرات إلى نزوح نحو 9 ملايين إيراني من المدن الكبرى خلال الضربات بحثًا عن الأمان، مما شلّ الأنشطة الاقتصادية في طهران وأصفهان وغيرها. كما أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز – وإن كانت لم تنفذ – تسببت بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية خلال أيام الحرب الأولى. هذا الارتفاع صبّ في مصلحة إيران نقديًا على المدى القصير (مع كل ارتفاع في سعر البرميل)، لكنه أضر باقتصادات مستوردي الطاقة وأثار قلق الأسواق الدولية. بالنسبة لإسرائيل، أدت حالة الطوارئ إلى تباطؤ اقتصادي مؤقت؛ إذ أغلقت العديد من الشركات أبوابها خاصة في منطقة تل أبيب وحيفا التي تعرضت للقصف، وتكبد قطاع الطيران والسياحة خسائر مع توقف الرحلات الجوية وتحويلها. لكن الأثر الاقتصادي على إسرائيل بقي محدودًا نسبيًا نظراً لقصر مدة الحرب والدعم الأمريكي والدولي السريع لاقتصادها. إقليميًا، دفعت دول الخليج، المستفيدة من أسعار النفط، ثمنًا من جانب آخر تمثل في تراجع الثقة بمناخ الاستثمار نتيجة التوتر الإقليمي، قبل أن تعود أسواقها للتعافي مع إعلان الهدنة. وفي إيران، تفاقمت أزمة العملة والتضخم مع ارتفاع الإنفاق العسكري خلال المواجهة وتهافت الناس على شراء السلع الأساسية تحسبًا للأسوأ. من جهة أخرى، برزت كلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في إيران كعبء ثقيل طويل الأمد، إذ سيتطلب إصلاح المنشآت النووية والعسكرية سنوات من العمل وكلفة بمليارات الدولارات في ظل استمرار العزلة والعقوبات. هذه الأعباء الاقتصادية ستقوّض تعافي إيران وتجعلها أكثر ارتهانًا لدعم حلفاء مثل الصين وروسيا في الفترة التالية للصراع.
باختصار، كشفت الحرب قصيرة الأمد عن حدود القوة لدى الطرفين: إسرائيل أثبتت قدرتها على توجيه ضربة موجعة إلى قلب المشروع النووي الإيراني وتفوقها التقني والاستخباري، لكنها أدركت عجزها عن فرض اي نوع من الاستسلام في غياب حل سياسي ودون دفع ثمن اقتصادي ودولي باهظ. وإيران أظهرت أنها قادرة على الصمود والرد وإلحاق الأذى رغم فارق القوة، لكنها خرجت اضعف عسكريًا ومعرضة لخطر استراتيجي أكبر في المستقبل إذا لم تعالج ثغراتها. وعليه، انتهى النزاع إلى توازن سلبي (negative equilibrium) حيث لا أحد انتصر بالكامل ولا انهزم تمامًا، إنما جرى احتواء مؤقت لصراع أوسع بوسائل عسكرية محدودة، فيما الأسباب الجذرية ظلت دون معالجة. هذا التوازن السلبي مهدد بالانهيار في أية لحظة إذا اختارت أي من الدولتين استئناف المواجهة لتحقيق نصر حاسم غاب هذه المرة.
التداعيات الإستراتيجية بالنسبة لتركيا
خرجت تركيا – القوة الإقليمية الصاعدة – من هذا النزاع المعقد في موقع مراقب قلق، تحاول تجنب ارتدادات الحرب المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تسعى لاقتناص مكاسب استراتيجية غير مباشرة على حساب كل من إيران وإسرائيل في ظل حالة الجمود الحالية. انتهجت أنقرة خلال الحرب دبلوماسية نشطة وحذرة؛ فقد سارعت إلى إدانة الضربات الإسرائيلية ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بل إن الرئيس رجب طيب أردوغان ذهب أبعد واعتبر الهجوم الإسرائيلي على إيران “إرهاب دولة” متوعدًا بأن تركيا سترفع جاهزيتها الدفاعية لمنع أي جهة من مجرد التفكير في مهاجمتها. في الوقت نفسه عرضت أنقرة التوسط لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ساعيةً لإبراز نفسها كصانع سلام إقليمي وكوسيط مقبول. هذا الموقف المزدوج – إدانة إسرائيل بقوة مع البقاء على مسافة من التورط العسكري – عكس استراتيجية تركية براغماتية لتفادي استعداء الرأي العام الإسلامي من جهة وعدم قطع شعرة التواصل مع الولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى.
وعلى الرغم من عدم انخراطها المباشر، شعرت تركيا بآثار الحرب اقتصاديًا وأمنيًا بشكل ملحوظ. فبمجرد اندلاع القتال، ارتفعت أسعار النفط لمستويات أثقلت كاهل الاقتصاد التركي الهش أصلًا، إذ تستورد أنقرة الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية. ووفق تحليل اقتصادي، أسهمت الحرب في تفاقم أزمة التضخم التركي وأربكت خطط الاستقرار التي تتبعها الحكومة، مع تجاوز سعر النفط 74 دولارًا للبرميل مما يهدد بزيادة عجز الحساب الجاري التركي. وتحوّل حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز – الذي يؤمن نحو 16% من حاجات تركيا السنوية – إلى نقطة ضعف بعدما تعرض لضربات إسرائيلية عطلت إنتاجه جزئيًا. أي تعطل طويل هناك قد يحرم تركيا من إمدادات غاز حيوية ويرفع أسعار الطاقة المحلية، خصوصًا أن العقوبات ستصعّب على طهران إصلاح الأضرار سريعًا. بذلك وجدت أنقرة نفسها في موقف حرج: حرب ليست طرفًا فيها لكنها تهدد أمنها الطاقي واستقرار اقتصادها الداخلي بشكل مباشر.
أمنيًا، رفعت تركيا مستوى التأهب على حدودها الشرقية طوال النزاع. فهي تتشارك مع إيران حدودًا طويلة (نحو 560 كم) ووعرة، وعند اشتداد القصف الإسرائيلي تواردت أنباء عن محاولات بعض المدنيين الإيرانيين الفرار باتجاه الأراضي التركية. ورغم نفي أنقرة حدوث موجة لجوء كبيرة، فقد شددت الدوريات ونشرت تعزيزات على الحدود تحسّبًا لأي طارئ. ولم يكن هاجس اللاجئين وحده ما أقلقها، بل أيضًا احتمال استغلال حزب العمال الكردستاني (PKK) وحلفائه للفوضى. فمن المعروف أن لطهران تاريخًا في توفير ملاذ لعناصر من حزب العمال أو جناحه الإيراني (PJAK) في المناطق الحدودية. ومع الفوضى الناجمة عن القصف، برزت خشية في أن تُفتح ثغرات أمنية يتسلل منها مسلحون أو أسلحة عبر إيران إلى تركيا. هذه المخاوف ليست نظرية؛ إذ تشير سوابق تاريخية إلى ازدهار أنشطة المجموعات الكردية المسلحة أثناء الحروب الإقليمية (كما حصل بعد 2003 في العراق وفي أثناء الحرب السورية). وبالفعل، التقطت الأجهزة التركية دعوات من حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) لعناصره باستغلال ما وصفه بـ”الفوضى الخلاقة” وشن عمليات جديدة، مستلهمين شعارات حركة “المرأة، الحياة، الحرية” الاحتجاجية. عليه، رأت أنقرة في استمرار الحرب خطرًا مضاعفًا: تفجر جبهة عنف داخلية كردية بالتزامن مع اضطرابات اللاجئين. وقد سارعت الحكومة إلى طمأنة الشارع بأنها لن تسمح بتكرار موجات لجوء كالتي شهدتها إبان سقوط كابول 2021 أو الحرب السورية، مبرزةً أنها استكملت بناء جدار حدودي فاصل مع إيران يراقَب إلكترونيًا ويصعب اختراقه. هكذا، وضعت الحرب إسرائيل وإيران تركيا أمام تحديات أمن قومي عاجلة دفعتها لتعجيل بعض خططها الدفاعية الداخلية، مثل مشروع منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى “القبة الفولاذية” المحلية التي يريدها أردوغان حصنًا يحمي سماء تركيا في المستقبل – رغم إقرار الخبراء الأتراك أن إنجازها يحتاج خمس سنوات على الأقل.
رغم هذه المخاطر والسلبيات، وجدت تركيا في مآلات الحرب وتوازناتها فرصة لتعظيم نفوذها الإقليمي على المدى المتوسط. فخروج إيران من المواجهة ضعيفة ومستنزفة يصب مباشرة في صالح أنقرة، التي تنافس طهران تاريخيًا على النفوذ في المشرق. لقد أبدت القيادة التركية ارتياحًا مبطنًا لتراجع قوة حلفاء إيران الإقليميين حتى قبل الحرب؛ فعندما اغتالت إسرائيل زعيم حزب الله السيد حسن نصرالله أواخر العام الماضي، أصدر أردوغان بيان تعزية للبنان تجنّب ذكر اسم نصرالله ذاته. هذا التجاهل المتعمّد فُهم على أنه شماتة تركية ضمنية بإضعاف ذراع من أذرع إيران طالما قوض مصالح أنقرة. وعقب الحرب الأخيرة، تجد تركيا أن خصمها الإيراني بات أقل قدرة على مزاحمتها في ملفات عدة. في سوريا مثلًا، أدى تغيير النظام الى تعاظم النفوذ التركي على حساب ايران وروسيا. ويمكن لأنقرة الآن توسيع هامش حركتها شمال سوريا وربما انتزاع تنازلات أكبر في مفاوضات ترتيب الوضع هناك دون خشية فيتو إيراني قوي. وفي العراق، قد تستفيد تركيا من إضعاف الميليشيات الموالية لإيران لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري، سواء عبر اتفاقيات مع حكومات بغداد وأربيل أو عبر ضربات مركزة على معاقل الـ PKK في جبال قنديل مستغلة انشغال طهران بوضعها الداخلي. حتى في لبنان، برحيل نصرالله وانشغال إيران بمصائبها، ترى أنقرة مجالاً لمد الجسور مع مكونات سنية وتعزيز نفوذ ثقافي واقتصادي كان محدودًا سابقًا. بعبارة أخرى، الفراغ الذي يخلّفه انكفاء إيران إقليميًا يمثل فرصة سانحة لتركيا لملئه وتمديد ظلال نفوذها من شرق المتوسط إلى الخليج.
على الجهة الأخرى، تدرك أنقرة أن إسرائيل ستكون أقل اندفاعًا بعد هذه الحرب، وأكثر حذرًا من فتح جبهات جديدة، مما يمنح تركيا حرية أكبر لحركة مناورة إقليمية. ومن المفارقات أن إسرائيل نفسها صارت تنظر بعين الريبة إلى أنقرة باعتبارها التهديد البعيد القادم؛ حيث يرى بعض المحللين الغربيين أن حرب إسرائيل مع إيران ربما كانت “بروفة” لمواجهة مستقبلية محتملة مع تركيا إذا واصل أردوغان نهجه الحالي. فتركيا في نظرهم تسير على خطى إيران: مشروع صواريخ ذاتي وتلميحات نووية تحت ستار برنامج مدني، ودعم حركات تعتبرها إسرائيل إرهابية مثل حماس وحتى تسهيل نشاطها على الأراضي التركية. هذه القراءة قد تدفع واشنطن وتل أبيب إلى فرملة الاندفاعة التركية مبكرًا. وقد بدأ بالفعل بعض صقور واشنطن بالدعوة إلى ممارسة ضغوط على أنقرة شبيهة باستراتيجية “الضغط الأقصى” التي اتبعت مع طهران، عبر عقوبات إذا لزم الأمر، بغية ثني تركيا عن طموحاتها الإقليمية الخطرة. وتعي أنقرة أن أي تحالف غربي ضدها سيكون مكلفًا، لذا فهي تبذل جهدًا للموازنة: تُظهر دعمها العلني للقضية الفلسطينية ولطهران إعلاميًا، لكنها بحذر لا تتجاوز خطوطًا حمراء معينة تبقي علاقاتها مع واشنطن ضمن حدود السيطرة. ومع انتهاء الحرب الإسرائيلية-الإيرانية دون غالب أو مغلوب، يتوقع أن تركيا خرجت منها في موقع المستفيد الهادئ: فقد تجنبت دفع كلفة مباشرة، وحافظت على علاقات فاعلة مع مختلف الأطراف، وفي الأثناء تضاعف مكاسبها تدريجيًا في ساحات فرعية مستغلة إنهاك منافسيها.
ومما يعزز المكاسب التركية، تنامي صورتها كمدافع عن المسلمين في أعين الرأي العام العربي والإسلامي. فأردوغان بإدانته اللاذعة لإسرائيل كسب نقاطًا شعبية. الشارع في العديد من الدول الإسلامية احتفل بموقف أنقرة ويقارنها بمواقف بعض الحكومات العربية التي بدت صامتة أو مرتبكة. هذا الرصيد الشعبي يمنح تركيا قوة ناعمة إضافية لتعزيز حضورها الإقليمي سياسيًا واقتصاديًا. وقد نرى تركيا توظف ذلك في عقد اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة مع دول عربية، مستفيدة من شعور هذه الدول بأن أنقرة كانت أكثر جرأة في مواجهة إسرائيل (ولو كلاميًا) من غيرها. على أن هذه الشعبية تأتي معها ريبة رسمية عربية من أجندة تركية “مستترة” لاستعادة نفوذ عثماني. لذلك ستحاول تركيا طمأنة العواصم الخليجية ومصر بأنها لا تسعى لمزاحمتها في زعامتها الإقليمية، وربما تستأنف سياسة تصفير المشاكل التي انتهجتها قبل سنوات مع جيرانها العرب لكسبهم إلى صفها أو على الأقل تحييد عدائيتهم.
في المحصلة، جمود الحرب بين إسرائيل وإيران أتاح لتركيا هوامش حركة استراتيجية أكبر. فعلى المدى القريب، ستعمل أنقرة على تحصين جبهتها الداخلية (اقتصاديًا وأمنيًا) من تداعيات أي مواجهة مماثلة، عبر تسريع مشاريع الدفاع الجوي وتعزيز تنويع وارداتها الطاقية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على إيران. وعلى المدى البعيد، ستسعى لاستثمار انشغال إيران بمداواة جراحها لإعادة رسم التوازنات في سوريا والعراق لمصلحتها، فيما تستفيد من استراحة المحارب الإسرائيلية لإطلاق مبادرات تكتيكية تعزز موقعها كلاعب لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية مقبلة بالشرق الأوسط. بعبارة أخرى، تجد تركيا نفسها اليوم – بعد 12 يومًا لم تطلق فيها رصاصة واحدة – أقرب إلى مركز ثقل التوازن الإقليمي، إن أحسنت استغلال الفرص وتجنب المطبات التي أفرزها الصراع الأخير.
دور دول الخليج ومصر
كشفت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية عن دور حاسم ومحوري لدول الخليج العربي ومصر في تهدئة الصراع والسعي نحو صياغة توازن قوى جديد في الإقليم. فمنذ اللحظات الأولى للتصعيد، اتخذت معظم العواصم العربية موقفًا صريحًا برفض الحرب وتحذير أطرافها من مغبة استمرارها. لقد عارضت دول الخليج ومصر علنًا الضربات الإسرائيلية على إيران واعتبرتها تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها. ظهرت هذه المعارضة في تغطية وسائل الإعلام العربية وتصريحات المسؤولين: على سبيل المثال، عنونت قناة العربية الخبر بـ«إسرائيل وإيران تبدآن هدنة تحت الضغط الأمريكي؛ ودول الخليج ترحب بالتهدئة»، ما يعكس ترحيب الخليج بوقف الحرب منذ اللحظة الأولى. وعندما بادرت واشنطن للتدخل دبلوماسيًا، تنفست هذه الدول الصعداء ورحبت بسرعة بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار الشامل. في الأيام التالية، كثّفت الدبلوماسية العربية – بقيادة السعودية وقطر وعُمان – اتصالاتها مع طهران وتل أبيب وواشنطن لتثبيت التهدئة ومنع انهيارها. قطر على وجه الخصوص برزت كوسيط فاعل، حيث استغلّت علاقتها الجيدة بالجميع (تستضيف قاعدة العديد الأمريكية وتحافظ على تواصل مع إيران) لتسهيل قنوات الرسائل بين واشنطن وطهران. وقد أشاد بيان لمجلس التعاون الخليجي بـ«حكمة قطر في احتواء تداعيات التصعيد» وأعرب عن تضامن كامل معها بعد تعرض أراضيها لهجوم إيراني. ولم تتردد العواصم الخليجية، وعلى رأسها الرياض وأبوظبي، في إدانة إيران فور استهدافها قاعدة العديد في قطر، مؤكدة أن ضرب منشأة على أرض دولة شقيقة أمر مرفوض تمامًا. هذا الموقف الخليجي الموحد ضد أي مساس بسيادة إحدى دول المجلس وجّه رسالة لطهران بأن الخليج جبهة واحدة في رفض تعريض أمنه للخطر، مهما كان الموقف السياسي من الأزمة الأصلية.
بعد تثبيت وقف إطلاق النار الهش، بدأت دول الخليج ومصر التخطيط لدور مستقبلي يضمن عدم تكرار مثل هذا السيناريو الكارثي ويكبح اندفاع كل من إسرائيل وإيران عسكريًا. تدرك هذه الدول أن غياب إطار أمني جماعي في المنطقة هو ما سمح باندلاع حرب منفلتة بهذا الشكل. لذلك برزت دعوات من عواصم عربية لإحياء فكرة وضع مدونة سلوك إقليمية تمنع الاعتداءات المباغتة. وقد لمح وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة إنشاء آلية جماعية للتشاور الأمني في الشرق الأوسط، وذكرت تقارير أن مصر دعت إلى قمة إقليمية طارئة لبحث سبل منع اندلاع حرب جديدة سواء بين إسرائيل وإيران أو أي خصوم آخرين. وفي هذا السياق، برز محور خليجي-مصري يعمل بشكل متناغم: فالسعودية والإمارات ومصر باتت ترى في نفسها حائط صد لمنع انزلاق المنطقة إلى حروب مفتوحة سواء بسبب المغامرات الإسرائيلية أو التوسعات الإيرانية أو حتى الطموحات التركية. ويمكن القول إن الدول العربية الرئيسية تسعى لتشكيل توازن جديد “عربي متمحور حول العرب”) يفرض نفسه على المشهد بعد هذه الحرب. هذا التوازن يقوم على مبدأ بسيط: لا يُسمح لأي قوة غير عربية (إسرائيل أو إيران أو تركيا) أن تستأثر بقيادة النظام الإقليمي أو تفرض أجندتها بالقوة، بل يجب أن يكون العمل الجماعي والدبلوماسية هما نهج حل الخلافات.
في حالة إسرائيل وإيران تحديدًا، بدأت دول الخليج ومصر التحرك على مسارين متوازيين لضبط إيقاع النفوذ لكليهما. فمن جهة، تعمل هذه الدول على تقوية نفسها عسكريًا واقتصاديًا حتى لا تبقى رهينة تجاذب هاتين القوتين. وفي الأيام التي تلت الحرب، سرّعت السعودية والإمارات خطط تحديث دفاعاتهما الجوية ضد الصواريخ والمسيرات – وهي خطوة تهدف لحماية أجوائهما سواء من صواريخ إيرانية طائشة أو أي اعمال مستقبلية قد تطالها. كما أعادت قطر والكويت تقييم إجراءات الأمن في المنشآت النفطية تحسبًا لأي استهداف إيراني انتقامي لو تجدد الصراع، خصوصًا بعد تهديد طهران أثناء الحرب بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز. هذه التحوطات تجعل من الصعب على إيران استخدام الورقة النفطية ضد الخليج دون رد فعل مؤلم. ومن جهة أخرى، سعت السعودية إلى تطمين إيران دبلوماسيًا بعد وقف إطلاق النار. فبادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالاتصال بالرئيس الإيراني الجديد (مسعود بزشكيان) ليؤكد دعم الرياض للتهدئة واستعدادها لحل الخلافات بالحوار. هذه الخطوة تعكس حرص السعودية على الاستثمار في سياسة الانفتاح على طهران التي بدأتها باتفاق بكين في مارس 2023. الرسالة كانت: نحن كعرب نرفض العدوان على إيران لكننا أيضًا نرفض تصعيدها – أي الالتزام بسياسة “لا غالب ولا مغلوب” بما يحفظ ماء وجه الجميع. كما لم تغفل دول الخليج توجيه رسائل واضحة لإسرائيل أيضًا. فالإمارات التي ترتبط باتفاقية سلام (إبراهيمية) مع إسرائيل، استدعت السفير الإسرائيلي لإبلاغه احتجاجها على تهديد أمن المنطقة، وذكّرته بأن أبوظبي وقّعت السلام لتعزيز الاستقرار لا لإعطاء شيك على بياض لحروب استباقية. بل إن الإمارات لوحت بشكل غير مباشر بأن استمرار النهج الإسرائيلي المتشدد قد يعرقل تطوير العلاقات الثنائية الناشئة. ويمكن فهم هذا التحرك على أنه استخدام الخليج نفوذه الاقتصادي والتطبيعي للضغط على إسرائيل لكبح أي اندفاع عسكري منفرد مستقبلاً.
إلى جانب التحركات الفردية، برز توجه نحو تنسيق عربي جماعي لمرحلة ما بعد الحرب. في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد بمبادرة مصرية-سعودية، طُرح تصور لإطلاق “حوار أمني إقليمي” برعاية الجامعة العربية يضم إيران وإسرائيل (عبر الأمم المتحدة) لبحث إجراءات بناء ثقة ومنها إعادة إحياء مفاوضات النووي الإيراني على أسس جديدة. وترى العواصم العربية أن عزل إيران تمامًا ليس خيارًا حكيمًا، لأن الضغط الأقصى ولد سابقًا سلوكًا أكثر خطورة من طهران. لذا فهي تميل إلى توظيف نفوذها الناعم – استئناف العلاقات التجارية والاستثمارية مع إيران – كحافز لطهران كي تلتزم بالتهدئة. مثلًا، أعلنت الإمارات أنها ستمضي قدمًا في خطط الاستثمار بميناء تشابهار الإيراني ومشاريع الطاقة هناك، شرط محافظة إيران على الاتفاق النووي وعدم القيام بأنشطة تهدد استقرار الجوار. كما قد تساعد قطر وعُمان في لعب دور الضامن لأي تفاهمات نووية جديدة عبر تقديم حوافز اقتصادية أو تسهيلات ائتمانية لإيران تخفف عزلتها. هذه المقاربة تأتي مكملة للعصا التي يلوح بها العرب متمثلة في الرفض الجماعي لأي عدوان إيراني جديد. فموقف الخليج الموحد ضد قصف طهران لقاعدة العديد مثال حي: جميع دول المجلس أدانت الهجوم بسرعة وبأقسى العبارات باعتباره انتهاكًا لسيادة قطر وتهديدًا للأمن الإقليمي. هذا الموقف القوي لم يترك لإيران مجالًا للمناورة لمحاولة شق الصف الخليجي أو كسب تعاطف أي دولة عربية. بالعكس، دفعها لإعطاء تبريرات “مطَمئنة” بأن الضربة كانت رمزية وبعيدة عن المناطق الآهلة في قطر. وهكذا حقق الخليج معادلة صعبة: إبداء التضامن مع قطر ضد إيران، وفي نفس الوقت مد يد دبلوماسية لطهران للحفاظ على التهدئة وعدم دفعها لليأس والتصرف المتهور.
أما مصر، فكان دورها مكملاً وحاسمًا ضمن هذا التحرك العربي. تمتلك القاهرة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ عقود، وكذلك خطوط تواصل مع إيران. خلال الحرب، حرصت مصر على توجيه تحذيرات مبطنة لإسرائيل بأن التمادي في ضرب إيران قد يشعل اضطرابات إقليمية لا تُحمد عقباها، وربطت ذلك صراحة بتأزم الموقف في غزة حيث لا تزال الحرب هناك مستعرة منذ 2023. وقد دعت مصر تل أبيب بوضوح إلى الالتفات للجبهة الفلسطينية ووقف عملياتها في غزة كمقدمة لنزع فتيل التوتر الإقليمي الأوسع. كذلك عززت القاهرة التنسيق الأمني مع الأردن ودول الخليج لمتابعة أي تهديدات حدودية قد تنشأ عن اضطراب إيران. وبعد وقف إطلاق النار، بادرت مصر إلى طرح مبادرة سياسية شاملة تتضمن استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية برعاية دولية، بالتوازي مع مفاوضات جديدة حول النووي الإيراني بمشاركة إقليمية. الفكرة المصرية هي معالجة جذور التوتر المزمن في المنطقة – القضية الفلسطينية والطموحات النووية الإيرانية – ضمن إطار واحد، بما يحقق صفقة كبرى تضمن أمن الجميع: إسرائيل تشعر بالأمان ولا تحتاج لضربات استباقية، إيران تحصل على ضمانات لبقائها دون سلاح نووي، والدول العربية تكبح تمدد تركيا وإسرائيل وايران معًا عبر هذه الترتيبات. ورغم طموح هذه الرؤية وصعوبة تحقيقها سريعًا، فإن مجرد تبني مصر لها ووضعها على طاولة البحث الدولي أعطى انطباعًا بأن الزعامات العربية استعادت زمام المبادرة الدبلوماسية بعد أن كانت في موقف المتفرج على صراعات الآخرين.
في الوقت عينه، تتحسب دول الخليج ومصر لتنامي النفوذ التركي كأحد تداعيات الحرب غير المباشرة. ففرملة إيران واستنزافها يعني تلقائيًا فراغًا نسبيًا ربما تندفع تركيا لملئه كما أسلفنا. وهذا أمر تنظر إليه العواصم العربية بحساسية عالية نظرًا للتنافس التاريخي مع أنقرة. لذلك يُتوقع أن تنتهج دول الخليج سياسة مزدوجة: انخراط محدود مع تركيا اقتصاديًا لاحتوائها، وتصميم خطوط حمراء لسلوكها الإقليمي. شهدنا بالفعل خلال الحرب كيف تواصلت الرياض وأبوظبي مع أنقرة لتنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية تجاه إيران، في بادرة حسن نية، لكن في الوقت نفسه استأنفت الإمارات تكريس تحالفها شرق المتوسط مع اليونان وقبرص وإسرائيل – وهو تحالف يشكل ضمنيًا حاجز صد أمام أي أطماع تركية في البحر المتوسط أو المنطقة العربية. ومصر من جانبها لن تتسامح مع أي محاولة تركية لاستغلال إضعاف إيران للتوغل أكثر في العالم العربي، سواء في ليبيا أو سوريا أو عبر تبني خطاب إسلامي شعبوي يحرج الحكومات العربية.
وبالتالي يُرجح أن تتعاون مصر ودول الخليج سرًا وعلنًا لكبح النفوذ التركي: قد يدعمون الأطراف المناوئة لتركيا في ليبيا سياسياً، ويكثفون الحضور العربي في العراق وسوريا لإبعاد هذين البلدين عن محور أنقرة. بل إن هناك أحاديث عن تنسيق مصري-خليجي-إسرائيلي غير معلن لمراقبة الأنشطة التركية، حيث تتشارك هذه الدول مصلحة احتواء أي تمدد تركي يضر بمصالحها (كما حدث سابقًا في ملف غاز شرق المتوسط). وهنا يظهر حرص الدول العربية على ميزان ثلاثي لا يميل كفته طرف غير عربي واحد: فبعد تحييد الخطر الإيراني مؤقتًا وكبح الاندفاع الإسرائيلي، حان الوقت لعدم السماح لتركيا باستغلال الوضع لتصبح المهيمن الجديد.
باختصار، تلعب دول الخليج ومصر دور الموازن الإقليمي العاقل عقب حرب إسرائيل وإيران. فقد أدركت هذه الدول أن سياسات المحاور والاستقطاب الحاد كانت وصفة لعدم الاستقرار، وأن عليها الإمساك بزمام المبادرة لحماية مصالحها أولا ومنع الآخرين من جر المنطقة إلى حافة الهاوية. لذا سنراها تدفع نحو حلول سياسية وتوافقات إقليمية تحدّ من تفرد أي قوة. وفي الوقت ذاته، تعزز مناعتها الذاتية أمنيًا واقتصاديًا كي تستطيع الصمود في وجه أي اضطراب قادم. هذا الدور العربي النشط يمثل عودة لإستراتيجية “القوة الوسطى” العربية التي تتعاون فيما بينها لملء أي فراغ وتوجيه دفة الأحداث. إنها محاولة لرسم معالم نظام إقليمي جديد: عربي القيادة، متعدد الأقطاب، يُفرمل المغامرات الإسرائيلية والإيرانية، ويضع خطوطًا حمراء لطموحات أنقرة، حفاظًا على استقرار الشرق الأوسط ككل.
موقف الولايات المتحدة وإدارة ترامب
اتسم موقف الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتذبذب المميز لنهجه، جامعًا بين الدعم العسكري الحازم للحليف الإسرائيلي من جهة، والسعي لاحتواء التصعيد ومنع انفلات الحرب من جهة مقابلة. في بداية الصراع، حرصت واشنطن على إظهار التأييد المطلق لإسرائيل دون الانخراط الفوري في القتال. لكن مع توسع نطاق الضربات الإسرائيلية واستنزاف مخزونها من الذخائر الموجهة، استجابت إدارة ترامب لطلب نتنياهو بالمساعدة المباشرة. في ليلة 22 يونيو، دخلت الولايات المتحدة خط النار عبر سلاح الجو، حيث شنت قاذفاتها الاستراتيجية ضربات “مطرقة منتصف الليل” على منشآت فردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات. وقد وصف ترامب هذه الضربات بأنها “سحقت تمامًا” تلك المنشآت، في إعلان انتصار مبكر. هذا التدخل العسكري الأمريكي العلني شكّل منعطفًا خطيرًا – إذ إنه لأول مرة تشارك الولايات المتحدة فعليًا في حرب تبدأها إسرائيل، وليس كرد فعل دفاعي كما في حروب 1967 و1973. ورغم اعتراض بعض مسؤولي البنتاغون على توسيع الحرب، مضى ترامب في قراره مدفوعًا بقناعته بضرورة تدمير القدرات النووية الإيرانية ومنحه إسرائيل ضوءًا أخضر طالما حلمت به.
بالمقابل، بمجرد تحقق هذه الأهداف العسكرية المحدودة، انقلبت أولويات ترامب نحو إنهاء الحرب سريعًا قبل أن تتورط بلاده في مستنقع طويل. فمع صباح 24 يونيو، وبعد أقل من 48 ساعة على انخراط واشنطن المباشر، أعلن ترامب عبر تغريدة على منصته Truth Social أنه تم التوصل لاتفاق كامل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. واصفا ما جرى بأنه “حرب الـ12 يومًا التي كان يمكن أن تستمر لسنوات وتدمّر الشرق الأوسط” لكن إدارته أوقفتها. هذا الإعلان المفاجئ جاء قبل ساعات فقط من موعد سريان الهدنة المتفق عليها، ما اعتبره البعض محاولة من ترامب لحصد الأضواء الإعلامية ونسب الفضل لنفسه في صنع السلام. وبالفعل، لم تخلُ ساعات التهدئة الأولى من عراقيل؛ إذ خرقت إسرائيل وقف النار المؤقت بهجوم جوي على رادار قرب طهران ردًا على رصد صاروخين مجهولين باتجاهها. أثار ذلك غضب ترامب بشكل علني، إذ صرّح للصحفيين “أنا مستاء جدًا من خروج إسرائيل هذا الصباح”، مستخدمًا لهجة نادرة في معاتبة حليف مقرب. وسرعان ما هاتف نتنياهو مؤنبًا وداعيًا للالتزام الفوري بالوقف، بل ونشر تغريدة يأمر فيها جميع الطائرات الإسرائيلية بالعودة لقواعدها فورًا وعدم التعرض لإيران. هذا المشهد أظهر جانبًا آخر من سياسة ترامب: زعيم لا يتوانى عن كبح جماح حتى أوثق الحلفاء إن رأى أنهم يتجاوزون الحدود التي رسمها. ويمكن القول إن ترامب تعامل مع نتنياهو وأوراق الحرب كتعامل مدير الصف: سمح له باللعب بالنار إلى حد معين ثم أوقفه بصرامة عندما خشي أن تكبر كرة اللهب أكثر من اللازم.
انعكست هذه السياسة المزدوجة على شبكة التحالفات الإقليمية. فمن ناحية، خرجت العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية أكثر التصاقًا بعد أن خاضا معًا جولة حرب ضد عدو مشترك. قدّم ترامب وحكومته دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا هائلًا لإسرائيل، وشعر نتنياهو بالامتنان وهو يثني علنًا على “وقوف ترامب بجانبنا”. وربما اعتقدت حكومة إسرائيل أنها حصلت على ضوء أخضر مفتوح لضرب أعدائها مع مشاركة أمريكية عند الحاجة. لكن بالمقابل، تركت طريقة ترامب في فرض وقف إطلاق النار مرارة ضمنية في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي رأى في ذلك انتقاصًا من حرية إسرائيل في حسم معاركها. ومع أن نتنياهو التزم علنًا بتعليمات ترامب واعتبره إنجازًا مشتركًا، إلا أن دوائر مقربة منه سربت تذمرها من “فرملة” ترامب للعملية قبل القضاء التام على البرنامج النووي الإيراني. هذا قد يخلق شرخًا خفيًا في الثقة مستقبلاً: هل يمكن لإسرائيل الاعتماد على استمرار الدعم الأمريكي حتى النهاية أم أن واشنطن ستضغط للتهدئة عند أول تهديد لمصالحها؟.
من ناحية أخرى، تعزز موقع دول الخليج ومصر في الإدارة الأمريكية بعد أن أثبتت هذه الدول أهميتها في إنجاح الوساطة وإنقاذ الموقف. أدرك ترامب وفريقه أن معارضة الرياض وأبوظبي المبكرة للتصعيد ثم دعمهم القوي للهدنة كانت عوامل مساعدة حاسمة. ولهذا حرصت واشنطن على التنسيق الوثيق مع الحلفاء العرب خلال وبعد الحرب. فمثلاً، أرسل ترامب وفدًا رفيعًا (ضم وزير خارجيته ماركو روبيو) إلى الرياض وأبوظبي والقاهرة لطمأنتهم بأن الضربات على إيران كانت ضربة جراحية محدودة لن تتكرر دون تشاور. وأثنى المسؤولون الأمريكيون على “حكمة” القيادة السعودية في التواصل مع طهران عقب الحرب، معتبرين ذلك عامل تهدئة مهم. بل إن الإدارة – المعروفة بنهجها المتشدد ضد إيران – لم تعارض مبادرة قطر للوساطة بين واشنطن وطهران من أجل اتفاق نووي معدل، في تغيير ملحوظ عن مواقف سابقة. يبدو أن ترامب بات أكثر إدراكًا لدور الخليج كقناة اتصال مع إيران لا غنى عنها، وكطرف قادر على تقديم ضمانات أو إغراءات اقتصادية تشجع طهران على ضبط النفس. وهكذا، ربما أعادت الحرب تشكيل أولويات التحالفات قليلًا: فأمريكا ترامب ستعتمد أكثر على شركائها العرب “المعتدلين” لضبط الإيقاع، بدل الاتكال المطلق السابق على إسرائيل وحدها كرأس حربة.
على صعيد العلاقة مع تركيا، واجهت واشنطن وضعًا معقدًا. فمن جهة، تركيا حليف في الناتو، لكن خلال الحرب بدا موقفها أقرب لإيران في خطابه. دان أردوغان إسرائيل بشدة وعارض الضربات، ما ولّد استياءً في الكونغرس الأمريكي وبين بعض مسؤولي الإدارة الذين اعتبروا أنقرة “حليفًا غير موثوق” في لحظة الأزمة. تفاقم التوتر عندما اتهمت إيران صراحة تركيا بالتواطؤ مع إسرائيل عبر سماحها باستخدام رادار قاعدة Kürecik الأمريكية في تركيا لرصد الصواريخ الإيرانية. نفت أنقرة ذلك قطعياً، لكن المعارضة التركية استغلت الموضوع للهجوم على أردوغان، داعية لإغلاق هذه القاعدة حتى لا تُجر تركيا لصراع ليس لها فيه ناقة. بالنسبة لترامب، الذي تربطه علاقة شخصية جيدة بأردوغان، كان لابد من التعامل بحذر. تجنبت واشنطن انتقاد أنقرة علنًا طوال الحرب، وحرص ترامب في اتصالاته المتكررة بأردوغان (ثلاث مكالمات خلال 48 ساعة كما أفادت تقارير) على طمأنته أن التصعيد لن يستهدف تركيا وأن بلاده تفهم موقف أنقرة الأمني. وفي الكواليس، ربما قدمت واشنطن وعودًا بتسريع صفقات أسلحة أو استئناف مفاوضات التجارة مع تركيا مقابل استمرار الأخيرة في ضبط النفس وعدم عرقلة الجهد الأمريكي. هذا الاحتواء الأمريكي لتركيا هدفه إبقاء أنقرة ضمن دائرة الأصدقاء رغم تباين رؤى الطرفين حيال إيران وإسرائيل. لكن لا شك أن ثقة واشنطن بأنقرة تلقت ضربة؛ فدعم تركيا العلني لإيران جعل صناع القرار الأمريكي يستشعرون خطر تقارب تركي إيراني روسي أوسع إذا همّشت تركيا. لذا ستعيد الإدارة تقييم كيفية التعاطي مع تركيا لضمان بقائها في الصف الغربي – ربما عبر مزيج من الترغيب (حوافز اقتصادية وصفقات) والترهيب (تلويح بعقوبات إن واصلت التقارب مع أعداء واشنطن). إذاً، من آثار الحرب أنها وتّرت علاقة أنقرة وواشنطن مؤقتًا وجعلت ملف تركيا أكثر إلحاحًا على طاولة البيت الأبيض، ما قد يؤثر على توازنات الناتو في المنطقة.
وعلى المستوى الدولي الأوسع، أثارت الحرب استقطابًا دبلوماسيًا أعاد رسم بعض ملامح التحالفات. فروسيا والصين نددتا بالهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران في مجلس الأمن، مستخدمتين لهجة حادة حيال واشنطن. الصين – التي كانت عرابة مصالحة الرياض وطهران – اعتبرت ما جرى تقويضًا لجهودها وحاولت مع روسيا تمرير قرار أممي يدين إسرائيل، باء بالفشل بالفيتو الأمريكي. هذا الحراك كشف أن الشرق الأوسط عاد ساحة تنافس دولي على النفوذ، حيث اصطفت بكين وموسكو مع طهران سياسيا” على الأقل، فيما أوروبا انقسمت: فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) أدانت البرنامج النووي الإيراني لكنها انتقدت خروج الضربة عن إطار الشرعية الدولية. كما سعت العواصم الأوروبية للوساطة قبل تدخل أمريكا بيأس (اجتمع وزراء أوروبا مع إيران في 20 يونيو لمحاولة ثني واشنطن عن الضربات) وبعد الهدنة، تجد إدارة ترامب نفسها أمام تحدي ترميم صورتها الدبلوماسية. إذ بدا لكثيرين أن واشنطن تصرفت كشرطي منفرد يقرر الحرب والسلام فجأة، مما أضعف ثقة الحلفاء التقليديين في أوروبا وآسيا. وسيحتاج ترامب لبذل جهد لتنسيق رؤيته مع الآخرين إذا أراد بناء تحالف دولي قوي لمواجهة إيران أو غيرها مستقبلا. ولعله استوعب الدرس، حيث لمح وزير خارجيته روبيو إلى انفتاح بلاده على اتفاق نووي جديد شبيه بـJCPOA ولكن “أقوى وأشمل”، في تغيير عن خطاب الرفض المطلق السابق. هذا التطور إيجابي لدول الخليج وأوروبا التي طالما دعمت الحلول الدبلوماسية. لكنه بالمقابل يثير قلق إسرائيل التي تخشى أي اتفاق يعيد تأطير برنامج إيران دون تفكيكه كليًا. وهكذا، تجد إدارة ترامب نفسها في توازن دقيق: بين طمأنة إسرائيل بأن يدها ستبقى مطلقة ضد الخطر الإيراني، وبين طمأنة الحلفاء الآخرين بأنها لن تسمح بانفجار جديد وتفضل العودة لمسار التفاوض. ومن المرجح أن ترامب – البراغماتي – سيسعى لمعادلة تحقق له مكاسب سياسية داخلية أيضًا: فقد قدّم نفسه للشعب الأمريكي كبطل أنهى حربًا كبيرة خلال 12 يومًا وأنقذ الأرواح والمصالح. وسيستغل ذلك انتخابيًا بلا شك. لكنه في الوقت ذاته سيروّج أنه وجّه ضربة قاصمة لإمكانات إيران العدوانية، فيرضي بذلك القاعدة المحافظة المناصرة لإسرائيل. إنه يحاول رسم صورة المنتصر وصانع السلام في آن واحد – وهي معادلة صعبة قد لا تصمد طويلًا ما لم يترجم الهدوء الحالي إلى ترتيبات أكثر ديمومة.
باختصار، برهنت إدارة ترامب عبر هذه الأزمة على نهجها الفريد: حد أقصى من القوة وحد أدنى من الالتزام الطويل. دعمت الحليف عند الحاجة (بكل قوة نارية ممكنة)، ثم ضغطت على الفرامل فجأة لتجنب التورط. هذا النهج ترك أثراً عميقاً على تحالفات المنطقة. فإسرائيل تعلمت أن ترامب يمنحها الدعم العسكري بلا حدود آنياً، لكنه قد ينتزع منها زمام المبادرة استراتيجيًا إذا تعارضت مع مصالحه الأكبر. ودول الخليج ومصر أدركت أن واشنطن ما زالت تحتاجها كلاعب اتزان إقليمي – وربما باتت تفضل التنسيق معها لكبح سلوك إسرائيل وإيران معًا، بعدما خبرت أن الاعتماد المفرط على إسرائيل وحدها قد يجر لمواجهات خطيرة. وتركيا أيقنت أن علاقتها بواشنطن مرهونة بضبط إيقاعها؛ فإذا تجاوزت خطوط الغرب الحمراء (بالتقارب الشديد مع إيران أو روسيا مثلا) فلا ضمان لبقائها في مأمن من عقوبات أو عزلة. وعلى صعيد إيران، ترسخ في ذهن صناع القرار بطهران أن لا ثقة في التعهدات الأمريكية السابقة – فقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي ثم قصف منشآتهم وهم يتفاوضون – ما سيدفعهم أكثر للارتماء في أحضان الشرق (موسكو وبكين) كضمان ضد أي عدوان جديد. هذه التحولات في شبكة العلاقات الإقليمية والدولية ستكون عاملًا حاسمًا في صياغة مرحلة ما بعد الحرب، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتعامل بحنكة للحفاظ على مصالحها وتحالفاتها وسط واقع إقليمي أكثر تعقيدًا من ذي قبل.
مستقبل ميزان القوى: نحو إطار جديد لاستقرار إقليمي متوازن
مع إسدال الستار على هذه الحرب القصيرة الخاطفة، يجد الشرق الأوسط نفسه أمام منعطف تاريخي لبلورة توازن قوى جديد يكبح جماح اللاعبين الإقليميين الكبار – لاسيما تركيا – ويمنع انزلاق المنطقة مجددًا نحو حافة الهاوية، مع الحفاظ على درجة من الاستقرار بين إيران وإسرائيل. إن دروس حرب الـ12 يومًا قاسية لكنها واضحة: لا يمكن ترك الأمن الإقليمي رهينة لنزوات التصعيد المنفرد من أي طرف، ولا بد من آلية جماعية تضبط الإيقاع وتوفر قنوات دائمة للحوار وتضع خطوطًا حمراء يتفق عليها الجميع. وفي هذا السياق، يبرز مقترح إنشاء إطار مؤسسي جديد يمكن تسميته مبدئيًا “منتدى أمن الشرق الأوسط” يضم اللاعبين الرئيسيين في المنطقة بمظلة دولية.
يقوم هذا الإطار على ركائز عدة لتحقيق التوازن المرجو:
1. قيادة عربية جماعية مدعومة دوليًا: كما ناقشنا، برزت دول الخليج ومصر كمرشحة لقيادة أي منظومة أمنية شرق أوسطية. فهي دول تملك شرعية عربية وإسلامية، وليست طرفًا مباشرًا في صراعات المحاور، وقد أثبتت رغبتها في الحلول السلمية. يمكن لهذه الدول تشكيل نواة مجلس أمن إقليمي يتولى مبادرات الوساطة وضبط التسلح. على سبيل المثال، إحياء مبادرة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط – وهي فكرة تبنتها مصر منذ زمن – قد تشكل أرضية مشتركة للحوار: تطمئن إسرائيل بأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وفي المقابل يدفع باتجاه نقاش (ولو مستقبلي) حول الترسانة النووية الإسرائيلية ضمن ضمانات أمنية شاملة للجميع. ستكون مظلة الأمم المتحدة مفيدة هنا، وربما رعاية من القوى الكبرى (أمريكا وروسيا والصين) لتوفير ضمانات والتزامات متبادلة. إن إشراك القوى الدولية إلى جانب قيادة العرب سيضمن جدية التنفيذ، ويمنح الإطار ثقلًا يمنع أي طرف إقليمي من التنصل بسهولة.
2. الحفاظ على توازن ردع بين إسرائيل وإيران: لضمان عدم تجدد الصراع بينهما، ينبغي التحرك على مسارين مكملين: مسار نووي دبلوماسي ومسار إقليمي أمني. في المسار الأول، إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد يحد بشكل صارم من قدرات إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات. على أن يتضمن الاتفاق هذه المرة دورًا لشركاء إقليميين – كالسعودية والإمارات وربما تركيا – في المراقبة أو المشاورات، حتى يشعر جيران إيران بالأمان. هذا سيكبح الدافع الإسرائيلي لتكرار الضربات لأن الخطر النووي سيكون تحت السيطرة الدولية. أما المسار الثاني، فإرساء اتفاقيات عدم اعتداء ثنائية أو متعددة الأطراف في المنطقة. يمكن تصوّر تفاهم غير معلن بين إسرائيل وإيران عبر وساطة عمانية مثلاً، يقضي بالتزام الطرفين بعدم استهداف أراضي الآخر مباشرة وعدم السعي لقلب النظام. قد يبدو هذا بعيد المنال في ظل العداء العقائدي، لكنه سبق أن حدث مثيله بين أمريكا والاتحاد السوفيتي (تفاهمات ضمنية خلال الحرب الباردة) عندما أدرك الطرفان حتمية التعايش الردعي. وسيكون دور اللاعبين العرب هنا توفير منصة حوار خلفية (كالقناة القطرية-العمانية) لإبقاء الاتصال مفتوحًا بين تل أبيب وطهران منعًا لسوء الفهم. إذا نجح هذان المساران، نكون أمام حالة “ردع مستقر”: إيران تبقى دون سلاح نووي لكنها آمنة من تغيير نظامها بالقوة، وإسرائيل تبقى متفوقة تقليديًا لكنها ملتزمة بعدم شن حرب استباقية جديدة طالما الخطر الاستراتيجي مكبوح.
3. كبح التفوق الإستراتيجي لتركيا عبر التوازن المضاد: تركيا، التي خرجت من الحرب دون إنهاك، قد تكون المستفيد الأكبر إذا لم يتم استيعابها ضمن الترتيبات الجديدة. هنا لا بد من اتباع نهج العصا والجزرة مع أنقرة. فمن جهة، تشكيل تكتل إقليمي مضاد لأي هيمنة تركية. هذا التكتل موجود بالفعل بصورة فضفاضة (اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر والإمارات وفرنسا تعاونوا في شرق المتوسط سابقًا)، ويمكن توسيعه وترسيخه. تخشى تركيا هذا التنسيق وتتفاداه، لذا مجرد تفعيله يشكل ضغطًا عليها. قد نشهد تعزيزًا للتحالف بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل بدعم خليجي – كإجراء مناورات عسكرية مشتركة منتظمة، وتأسيس آلية تشاور دائمة حول أمن البحر المتوسط. كذلك الدعم الغربي مهم هنا؛ إذ تستطيع واشنطن ضبط اندفاعة أنقرة عبر ربط بعض المنافع (كصفقة مقاتلات F-16 التي تريدها تركيا) بسلوكها الإقليمي. وقد يلوّح الكونغرس مجددًا بملف العقوبات (قانون CAATSA) إذا تجاوزت تركيا خطوطًا ما، مثل استضافة قيادات حماس أو الاستمرار في عرقلة توسع الناتو. هذا جانب العصا. أما جزرة استيعاب تركيا، فتكون عبر إفساح مجال لها للمشاركة في المنظومة الأمنية بدل بقائها خارجها كليًا. يمكن دعوة أنقرة للانضمام إلى منتدى أمن الشرق الأوسط المقترح بصفة مراقب في البداية، على أن تلتزم باحترام سيادة الدول والكف عن دعم أي تنظيمات معادية لجيرانها. إدماج تركيا اقتصاديًا أيضًا يخفف دوافعها التوسعية؛ فمثلاً، مشاريع الربط البري والبحري بين الخليج وتركيا إلى أوروبا، وخطوط الطاقة (كما ظهر مقترح ربط كهرباء العراق والخليج بتركيا)، هذه كلها تجعل تركيا شريكًا مستفيدًا من الاستقرار لا من الفوضى. الرهان هنا أن تحويل تركيا من منافس إلى شريك نسبي يقلل حاجتها لاستعراض القوة. بطبيعة الحال، سيظل لدى تركيا طموحها الإقليمي، لكن في ظل توازن معزز. وسيكون على أنقرة الاختيار: إما التعاون ضمن ضوابط النظام الجديد والاستفادة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، أو مواجهة عزلة وضغوط إن اختارت طريق المواجهة. وأغلب الظن أن براغماتية أردوغان – أو من سيخلفه – سترجح الكفة نحو التكيف إذا وجدت جدية وصلابة من بقية الأطراف في التصدي لأي مغامرات. لقد أظهرت الحرب أن تركيا نفسها لا تريد انفلات الأمور إقليميًا (اتصالات أردوغان المكثفة بترامب لوقف القتال دليل ذلك)، فهي تخشى تداعيات فوضى كبرى على حدودها. ويمكن البناء على هذا التخوف لضمان انخراطها الإيجابي.
4. تفعيل دبلوماسية وقائية ومنصات حوار منتظم: لا يكفي جمع الأعداء وقت الأزمات؛ المطلوب إنشاء قنوات حوار دائمة لتبريد أي سخونة قبل اشتعالها. عليه، قد نشهد إحياء مقترحات مثل “منتدى هلسنكي شرق أوسطي” يضم بالإضافة للدول العربية كلاً من إيران وتركيا وإسرائيل تحت رعاية او ترتيبات غير مباشرة أممية، لبحث إجراءات بناء الثقة تدريجيًا. يمكن لهذا المنتدى أن يبدأ بقضايا مشتركة أقل حساسية (كأمن الملاحة في الخليج، مكافحة الإرهاب، التغير المناخي والكوارث الطبيعية)، ويحقق نجاحات صغيرة تبني ثقة تدريجية. ثم ينتقل شيئًا فشيئًا لملفات أصعب. الفكرة أن يجلس ممثلو هذه الدول بانتظام على طاولة واحدة مباشرة او غير مباشرة كما حصل في مفاوضات النووي بين ايران والولايات المتحدة، فيعتادوا التواصل المثمر مما يقلل من سوء الفهم وسوء التقدير الذي قاد كثيرًا من الحروب. كذلك، تعزيز الاتصالات العسكرية الفنية مهم. مثلًا، إنشاء خط ساخن بين القيادات العسكرية في إسرائيل وإيران – عبر طرف ثالث محايد كعُمان – لمنع الحوادث العرضية (كالتي كادت تنسف الهدنة حين زُعم إطلاق صاروخين بعد الاتفاق). كما يمكن توسيع آلية تفادي الصدام الحالية في سوريا (بين روسيا وأمريكا وإسرائيل وتركيا) لتشمل مناطق أخرى كالعراق أو الخليج عند أي تواجد عسكري متقارب. هذه الدبلوماسية الوقائية أقل وهجًا من الاتفاقات الكبرى، لكنها الزيت الذي يسهّل حركة التروس ويمنع الشرارة الأولى.
5. الحفاظ على حضور القوى الدولية بتوازن: سيبقى الدور الأمريكي ضامنًا أساسيًا لأمن حلفائه، لكن من الضروري أيضًا إشراك أوروبا والصين وروسيا بصورة بناءة. الصين مثلًا لديها مصلحة عميقة في استقرار الخليج لأجل الطاقة، ويمكن تحفيزها للضغط على طهران لكبح أي اندفاع انتقامي، كما فعلت جزئيًا خلال الحرب. روسيا رغم علاقتها بإيران لا تريد رؤية حرب شاملة قد تهدد مصالحها في سوريا. كما أن كلا البلدين (الصين وروسيا) لا يرغبان في دفع تركيا بعيدًا نحو الولايات المتحدة بالكامل. لذا فمصلحتهما أيضًا ضبط سلوك أنقرة بحيث لا تضطر واشنطن لمحاصرتها. هذا التداخل في المصالح يمكن استثماره لـتنسيق دولي أوسع داعم للإطار الجديد. مثلًا، يمكن إصدار ضمانات أمنية متعددة الأطراف لإيران: تعهد من الدول الخمس دائمة العضوية بعدم السعي لتغيير النظام في طهران بالقوة مقابل التزام إيران بالاتفاق النووي وعدم تهديد جيرانها. وضمانات موازية لإسرائيل: تعهد برد جماعي صارم على أي اعتداء نووي أو تقليدي يستهدفها، مقابل انضمامها لأي ترتيب إقليمي للحد من التسليح. هذه الضمانات الدولية ستعطي ثقة للأطراف الإقليمية في الالتزام بالمسار الدبلوماسي طويل الأمد.
6. معالجة ثغرات ومظالم أوسع: من المهم الإقرار بأن استقرار الشرق الأوسط لا يمر فقط عبر توازنات القوى العسكرية، بل أيضًا عبر حل النزاعات السياسية المزمنة. فالقضية الفلسطينية مثلاً تظل جرحًا نازفًا. وقد رأينا كيف أضعفت حرب غزة 2023-2024 صورة إسرائيل عالميًا وعزلتها، مما جعل دعمها ضد إيران أكثر تعقيدًا دبلوماسيًا. لذا، يتعين على النظام الإقليمي الجديد الدفع نحو معالجة عادلة لهذه القضية تكفل حقوق الفلسطينيين المشروعة. كما ينبغي العمل على تقريب وجهات النظر المذهبية والقومية في المنطقة؛ فالتوتر السني-الشيعي والعربي-الفارسي كان وقودًا غير مباشر للحروب بالوكالة. ولحسن الحظ، بدأت خطوات في هذا الاتجاه عبر الحوار السعودي-الإيراني، ويمكن توسيعها لمصالحة إيرانية مع بقية دول الخليج وتعزيز دمج العراق في محيطه العربي. هذه المصالحات ستسحب البساط من تحت أقدام من يسعى لتوسيع نفوذه باستغلال الانقسامات.
في الخلاصة، التوازن الجديد المنشود يمكن تشبيهه بكرسي ذي ثلاث أرجل متساوية: رجل عربية (تحالف خليجي-مصري-أردني مدعوم من الغرب)، ورجل غير عربية معتدلة (انخراط مسؤول لإيران وتركيا وإسرائيل ضمن ضوابط مشتركة)، ورجل دولية (رعاية وضمانات من القوى الكبرى). إذا تكاملت هذه الأرجل واستند الكرسي على أرضية حل المشاكل السياسية، يمكن للمنطقة أن تنعم باستقرار طويل وتمنع أي طرف من الانفراد بالتفوق. تركيا تحديدًا، والتي برزت كالقوة الإقليمية الأقل تضررًا من حرب 2025، ستجد نفسها أمام واقع توازني جديد: فهي لن تستطيع المضي في نهج الهيمنة الناعمة أو الصلبة دون أن تواجه ائتلافًا عربيًا صلبًا واصطفافًا دوليًا ضد أي تجاوز. وفي الوقت عينه، ستتاح لها فرصة الاستفادة اقتصاديًا وسياسيًا إن احترمت هذه اللعبة الجديدة. أما إسرائيل وإيران، فسيبقيهما التوازن الردعي والاتفاقات تحت سقف يمنعهما من كسر المعادلة بالقوة مجددًا. لا شك أن تحقيق هذا التصور طموح ومعقد، لكنه ليس مستحيلاً. فكما أظهرت أزمة الصواريخ الكوبية 1962 للعالم ضرورة إنشاء الخط الساخن بين واشنطن وموسكو وتوقيع معاهدات الحد من التسلح، ربما تصبح حرب الـ12 يومًا هذه نقطة تحول تدفع قادة الشرق الأوسط نحو نهج أكثر تعقلاً وتعاونًا. لقد دفع الجميع ثمنًا كافيًا لإدراك أن البديل – أي ترك الأمور للفوضى والصدام – سيكون أثمانه أعظم بما لا يقاس.
إن صناع القرار الإقليميين أمام اختبار تاريخي: إما أن يؤسسوا معًا نظامًا أمنيًا جماعيًا ينتشل المنطقة من دوامة الحروب الدورية، أو يتركوا الفرصة تفلت ليعيد كل طرف التسليح استعدادًا للجولة القادمة الأخطر. الخبرة الواسعة في جغرافية الصراع بالشرق الأوسط تخبرنا أن توازن القوى المستدام هو ذلك الذي يشعر فيه الجميع بالأمان الكافي لعدم شن الحرب، وبالرضا النسبي بحيث لا يُضطر أحدهم لكسر القواعد. هذا يتطلب ترتيبات شاملة: قوة ردع عند الحاجة، ودبلوماسية نشطة دوماً، وتنمية اقتصادية تربط مصالح الدول ببعضها. إن بناء مثل هذا التوازن الجديد مهمة شاقة لكنها ممكنة، وهي الطريق الوحيد لضمان ألا تتكرر “حرب الـ12 يوم” كحرب الـ50 يوم أو الـ100 يوم في المستقبل. المنطقة تقف على مفترق طرق، وما سيفعله اللاعبون الإقليميون اليوم سيحدد شكل الشرق الأوسط لعقود قادمة – إما شرق أوسط متوازن ومستقر يكبح المغامرات ويتيح للجميع الازدهار، وإما شرق أوسط تهيمن عليه قوة منفردة فتجر الآخرين إلى تحالفات مضادة وصراعات لا تنتهي. والمسؤولية الآن في أيدي من يملكون الرؤية والشجاعة من قادة المنطقة لترجيح كفة الخيار الأول.